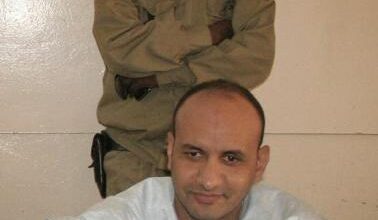من محاضرة الدكتور البراء في الثقافي المغربي حول أثر الواقع في صياغة الأحكام الفقهية في الخطاب الإسلامي المعاصر
 “بسم الله الرحمن الرحيم في البدء أشكر السيد مدير المركز المغربي الأستاذ محمد القادري على تشريفي بالمشاركة في هذا النشاط المبارك والمثمر الذي دأب على القيام به حتى أصبح المركز منارة إشعاع ثقافي وفكري معروفة ومعتبرة . وأشكر الحاضرين على تجشم السفر إلى هذا المكان وإصغاء الآذان للاستماع لهذه الإثارت ما أردت لها أن تكون إلا حفرا وتنقيبا في موضوع أحس أنه اليوم يشكل أكبر هم فكري بل حضاري يتوجب على المسلمين أن يولوه حقه من العناية. أما ما يخص الموضوع فهناكدوافع عديدة كانت وراء تفكيري فيه من أهمها:
“بسم الله الرحمن الرحيم في البدء أشكر السيد مدير المركز المغربي الأستاذ محمد القادري على تشريفي بالمشاركة في هذا النشاط المبارك والمثمر الذي دأب على القيام به حتى أصبح المركز منارة إشعاع ثقافي وفكري معروفة ومعتبرة . وأشكر الحاضرين على تجشم السفر إلى هذا المكان وإصغاء الآذان للاستماع لهذه الإثارت ما أردت لها أن تكون إلا حفرا وتنقيبا في موضوع أحس أنه اليوم يشكل أكبر هم فكري بل حضاري يتوجب على المسلمين أن يولوه حقه من العناية. أما ما يخص الموضوع فهناكدوافع عديدة كانت وراء تفكيري فيه من أهمها:
ازدياد طلب الشعوب الإسلامية في الوقت الحاضر على القائمين بأمر الدين لمعرفة ما يأخذون وما يذرون مما يأتيهم من مُنتجات الحضارة الغربية الفكرية والثقافية والسياسية والمادية، ثم إلحاحهم عليهم لكي يقدموا لهم البدائل في حال الرفض التي يمكن أن توفر للناس ما يعتبرونه اليومَ من الضروريات أو الحاجيات التي لا غنى لهم عنها. كما أن من هذه الدوافع أيضا قوة تسارع الأحداث المرتبطة بالإسلام عموما وتنامي كراهيته (islamophobie) عند الآخر، وما ينجر عن ذلك من التأثر به سلبا أو إيجابا، والإفراط في تدويل ظاهرة الإسلام الجهادي لدرجة أصبح معها حديثَ الساعة في وسائل الإعلام والأولوية في برامج السياسات الدولية على مستوييها الداخلي والخارجي. وليس أقل هذه الدوافع شأنا تصاعد ظاهرة الإسلام السياسي بقوة ملاحظةٍ بدءا من الربع الأخير من القرن الماضي لدرجة أصبح بها رقما أساسيا في المعادلة السياسية الدولية. ولاشك أن من أسباب تنامي هذا المد أنه يأتي في سياق رجعة قوية إلى الدين تطال البشرية جمعاء. فالتيار الإسلامي هو جزء من ظاهرة التدين الفردي والسياسي التي يشهدها العالم منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي والتي نجم عنها الصعود الملاحظ للحركات الأصولية عند الكثير من الأمم: مسيحية ويهودية وهندوسية، إلخ. وعندما نتكلم عن الإسلام السياسي فإننا نعني تيارا كبيرا يمتاز عن باقي الطيف الديني في المجتمعات الإسلامية برؤيته التي يريد لها أن تكون تجديدية وفي بعض الأحيان تحديثية، وبتركيزه على أن الإسلام شأن اجتماعي قبل كل شيء وهذا ما جعل الهم السياسي حاضرا كثيرا في خطابهم في مقابل تيار آخر قد لا يمانع في ذلك ولكنه يعتبر الشأن الفردي هو اللبنة والأساس. وتبقى السمة البارزة لهذا التيار ذات طابع سياسي حركي أو حزبي تتجلى في خط فكري وسياسي قوامه مبدأ الحل الإسلامي. فهو طرح يقول إن الإسلام ليس عبارة عن ديانة فقط، وإنما هو نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات الدولة ومرافقها. ولا غرابة في تنامي ظاهرة الصحوة الإسلامية، فالخطاب الديني نافق العرض عند المجتمعات الإسلامية، يحظى بالقبول مهما كان ويرحب به كثيرا. لأن وعيها وعقيدتها ومثلها مبنية كلها على الدين لذلك كان من الطبيعي أن يجد القبول من قطاع واسع من المسلمين الذين يمثل بالنسبة إليهم معتقدا ومنهجا وخلاصا. فهذه المجتمعات حاضنة لهذا النمط الخطابي بشكل طبيعي خاصة أن المسلمين يشعرون بالكثير من الإذلال والإهانة وإبراز العداء من خصومهم في مختلف بقاع العالم. هذا فضلا عن ما سبق وأن جرب المسلمون خلال عقود عدة من مختلف الإيديولوجيات الاشتراكية والقومية والليبرالية التي فشلت في الخروج من المأزق ولم تف بما كانت تعد به من الرخاء والعدل والحرية. ينضاف إلى ذلك واقع الفقر والإقصاء القوي الذي يعرفونه غير أن هذا النجاح القوي للخطاب الإسلامي في مجالات الحشد الجماهيري والمنازلات الانتخابية والذي رافقه نوع من النجاعة في التدخل في الميدان الاجتماعي، تعترضه تحديات كثيرة على المستوى الفكري والسياسي والتخطيطي. يعبَّر عنها خصومهم غالبا بالعجز عن طرح البدائل الواضحة والمنسجمة لإقامة الدولة، وبأن شعار “الإسلام هو الحل” الذي يرفعونه يكاد يكون مفرغا من محتواه لأنهم لا يمتلكون في الواقع الحلول الكافية للمشاكل المطروحة على المسلمين. ولذا كثيرا ما صرحت الأطراف المناهضة لهم من خارج المرجعية الإسلامية بأن الإسلام ليس مطالبا بالإقحام في مجال الحياة العامة وإنما هو شأن فردي. لذا يحتد الطلب اليوم على الفقهاء والمفكرين من طرف الفئات الفاعلة في المجتمع والمنافسة لهم من أجل خطاب ديني عقلاني يدعو للسلم والتعارف، ينسجم مع واقعٍ متعدد الهويات والأديان والانتماءات، ليس على مستوى العالم المفتوح فقط، وإنّما داخلَ الوطن الواحد؛ خطاب ديني قادرٌ على تهيئة المناخ الملائم لِدفع الفضاءِ العامِّ لإنتاج منظومات أخلاقية تنهض بالمجتمع، وقادر على مُزايحة الخطابات التي ترتكز على التصنيف العقائدي، والتي تَستغلُّها، وتستغلُّ، الصراعات السياسية، والقابلة للتوظيف إقليمياً ودوْلياً ضد الإنسان، وضد الجوهر الأخلاقي للدّين. كما آن الآخر (الغرب) الذي يشارك في إدارة الشأن الداخلي للشعوب الإسلامية، يطلب من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين – لأنهم هم المزاحمون له في الأمر العام- وبإلحاح أن يبدوا رأيهم وموقفهم من قضايا عديدة تمثل ما يعرف اليوم بـ”القيم الإنسانية”. كما يطلب منهم هو وغيره من أطياف مجتمعهم أن يوضحوا موقفهم غير الرافض لقيمههذه ويبينوا طبيعته بوضوح وفي أي خانة يجعل هل في باب الأهداف الاستراتيجية أو تلك التكتيكية كما يرى هؤلاء. هذا فضلا عن المشاكل الواضحة التي أصبح التعرف عليها متاحا للجميع والتي تحتاج إلى التفكير في مشروع حضاري بمفهوم الكلمة يعمل على النظر المثمر في شتى مناحي الحياة ومواطن التأزم في المجتمع الإسلامي. فليس وضع المسلمين في عالمنا اليوم بحسن بل يبدو وكأنه يمر بأحلك فتراته، وذلك لقوة وعظم التحديات التي تواجههم سواء على الصعيد الروحي والحضاري، أم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أم على الصعيد العلمي والفكري، أم على الصعيد السياسي والأمني. فعلى الصعيد الروحي والحضاري يجابه المسلمون تحديا كبيرا يتجلى في التدهور البالغ في المنظومة الأخلاقية والتزايد المتنامي في الانقسام والتخاذل على أساس المذهب والطائفة والعرق والجهة، كما يتجلى في انتشار الخوف غير المبرر من الإسلام في أغلب بلاد الغرب والمشرق بوصفه الخطر القادم الذي يهدد الحضارة العالمية. هذا الخوف الذي أصبح جزءا من مخيلة الشعوب غير المسلمة (الإسلاموفوبيا”) يتم الترويج له عن طريق نظرية صدام الحضارات التي تقتضي أن الصدام أمر حتمي واقع لا ريب فيه. ولاشك أن المقصود في الحقيقة هو الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، نشاهد تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي لأغلب بلدان المسلمين، ففي حين يبلغ عدد المسلمين نسبة 23 في المائة من سكان العالم نجدهم يمثلون نسبة 40 في المائة من فقرائه، وفي حين يمتلك الغرب النصراني اليهودي نسبة 70% من الثروة العالمية نجد أن المسلمين لا يمتلكون سوى نسبة 5% من هذه الثروة. أما على الصعيد العلمي والفكري، فالتحديات تزداد وتتضاعف يوما بعد يوما فنسبة الأمية في صفوف المسلمين تصل إلى 46،5% ، وترتفع في أوساط النساء في بعض البلاد الإسلامية إلى 60 في المائة. كما أن النجاعة والكفاية في الدرس الجامعي والبحث العلمي هي في أدنى مستوياتها. أبرز ذلك تقرير نشرته مؤخرا جامعة شانغهاي(Shanghai Jiao Tong) يرتب الأربعمائة جامعة الأعلى في مستوى التكوين والبحث من بين الجامعات العالمية ولم تظهر في اللائحة أية جامعة من جامعات العالم الإسلامي. وعلى الصعيد السياسي والأمني، يشهد العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه سلسلة من الفتن والصراعات المسلحة بسبب استشراء ظاهرة الإرهاب سواء ما تقوم به الدول والقوى العظمى أو ما تقوم به الجماعات المتطرفة زادت من حالة التشرذم والتخاذل والتفكك بين أبنائه، وأَدَّتْ إلى انعدام الأمن والفوضى واختلال لهذه الدوافع مجتمعة سنسعى في هذه الورقة إلى إبراز الكيفية التي حاول بها أصحاب الفكر المسلمون المعاصرون أن يوائموا بين التزاماتهم الدينية وبين مُنتجات الحضارة الحديثة الاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية والمادية التي أصبحت اليوم – بحكم نجاعتها النسبية، وبحكم سيادة مُنتجيها شبه المطلقة – تفرض نفسها على المسلمين كغيرهم من شعوب المعمورة. تلك المُنتجات التي ترى فيها الغالبية العظمى من الأمم الحلولَ المثلى للنجاح في الخروج من ربقة التخلف والتبعية، وكسب رهان الحاضر لما وفرته من سعة في العيش ووفرة في أسبابه، وتغلب على الطبيعة وانفتاح في آفاق العلم والمعرفة. وهذا المطمح الذي نسعى إلى تحقيقه يفترض منا طرح الأسئلة التالية التي نريد منها أن تكون موجها منهجيا في معالجة الموضوع وتلخيصا مكثفا لمضمونه وهي:
ما هو الخطاب الإسلامي المعاصروهل يتفق أصحابه في أطروحاتهم وطرق عملهم؟ ·
كيف واجه منتجو هذا الخطاب أو الخطاباتهذه الظواهر الجديدةوما هي الأدوات التي استعملوا؟ ·
هل قدموا فقهيات متسقة مع الأنموذج الذي يتبنونه في تنزيل الخطاب الشرعي على الواقع تتسم بالكفايات الضرورية وبالخصوص الكفاية النفسية والملاءمة المجتمعية؟
1. الخطاب الإسلامي المعاصر:
أشكاله وآفاقه إذا انطلقنا من تعريف الخطاب الإسلامي بأنه مجموع الجهود الفكرية الرامية إلى جعل تعاليم الإسلام تحتل موقعا مؤثرا وأوليا في حياة المجتمعات، فإننا نرى أن هذا الخطاب ظل منذ النصف الأخير من القرن الأول للهجرة يتردد بين اتجاهين طبعاه في بعديه العقدي والعملي على طول مساره هما: مدرسة النص ومدرسة التأويل. وقد ترجمت هذا التمايزَ في بعده العقدي مدرستا: العقل والنقل، كما ترجمته في جانبهالعمليمدرستا الأثر والرأي.
واستمر هذان الاتجاهان طيلة عدة قرونيتجاذبان الشرعية ويتنافسان في الميدان ويتبادلان التأثر والتأثير في مناخ فكري وثقافي “خالص” يمكن أن نصفه بأنه مستقل لا ينفعل بالغ الانفعال بالمناخات الفكرية والثقافية الأجنبية عليه. ولا يعني هذا أنهما، وبالخصوص أصحاب مدرسة التأويل، لم يتأثرا بفكر ومعارف حضارات أخرى وعلى رأسها الحضارة اليونانية، بل يعني أنهم، وإن تأثروا بتلك الروافد،لم يكونوا منفعلين بها غالبا وإنماأفادوا منها من موقع القوةالذي سببته غلبة الإسلامآنذاك وسيادة وجاذبية نموذجه الحضاري. فكان إدماج ذلك الفكر وتلك المعارف في المنظومة العقدية والفكرية الإسلامية سهلا ومتحكما في هلأنه وليد هضم تام لذلك الموروث، ونتيجة تحكم فيه يتسم بالانسجام والنسقية. غير أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر حدث منعرج كبير في مسار تفكير تينكالمدرستينجراء الاحتكاك المباشر بالحضارة الغربية التي تتصف بالغلبة لقوتهاالمرهبة ونموذجها الجاذب، كما تتصف بالنزوع إلى التوسع ودمج الآخر، أي إلى أن تكون الحضارة الكونية، فجاءت صدمة أهل العلم والفكر من المسلمين قوية لعمق الفجوة الحضارية بين الطرفين وقوة دفع التحديات الواردة عليهم. كماجاءت ردة فعلهم مرتبكةوانفعالية في معظمهالانعدام فقه يستوعب الجديد ويحسم في أحكامه. هذا بالطبع مع غياب نظام سياسي قوي يعمل هو الآخر على الأخذ بأسباب القوة وتطوير النموذح الحضاري والثقافي الإسلامي ونقله خارج الحدود. ولم يكن سواد المسلمين بأحسن حالا، فقد أحدث التواصل بينهم وحضارة الغرب، وتغلغلمدنيتهفي حياتهم العامة والخاصة أثراً عميقا في طبيعة علاقتهم بدينهم وبتراثهم الفكري والثقافي. لقد تزعزعت ثقة مجموعة منهم بهويته الإسلامية،وقد يكون السبب في ذلك راجعا إلى عاملين: أولهما: ظهور هذه الحضارة في إطار دنيوي بحت مما سهل استقبالها وأبعد شبح التبشير والصراع الديني عنها. والثاني: قناعة غالبية المتعلمين من المسلمين بكونيتها، وبأن صورتها الدنيوية بعد أن انعتقت من ربقة الدين، هي العتبة القصوى لنضج حضارة الإنسان. فتلكالصورة لا يمكن أن يعتورها تدهور ولا يصيبها فساد، بل من المفترض أن تقود الإنسانية إلى طريق الوحدة الاجتماعية والثقافية. فكيف كانالتفكير في الكيفية التي يمكن أن تحفظ بها البيضة وتصان وحدة الأمة،فلا تعصف رياح التغريب العاتية بالمسلمين فتقتلع جذور هويتهم وتقوض دينهم من أساسه؟لقد جاء الحلول مختلفة استتباعا لاختلاف أصحابها في المنطلق النظري ولتباينهم في تقييم الوضع، وانبنى على أساسها خطاب إسلامي متباينفي خلفياتهالفكرية،ومختلففيتقنياتتطبيقه. ويمكن من خلال نوع من التتبع المستقرئ لهذا الخطاب أن نصنفه في ثلاثمجموعات: ·
مجموعةتذهب إلى وجوب الرجوع إلى النص (القرآن والسنة) وإلى ما كان عليه السلف باعتباره المخلص والمنقذ،إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وسنجد أن هؤلاء ذهب بعضهم إلى رفض كلما هو فكر وافد وترجموا ذلك في نظريات وممارسات معروفة.وقد سمينا أصحاب هذه المجموعة بـ”المدرسة النصية السلفية”.
مجموعةتقول بإمكانية معالجة هذه المستجدات من خلال الرجوع إلى النص وإلى التراث التشريعي المذهبي والعقدي الدائر حوله، والمتسم بالتنوع والثراءوالحكم بما يخولانه. وسنجد أن هؤلاء حاولوا إيجاد الحلول لبعض النوازل المطروحة عن طريق النظر في الأقوال المذهبية واختيار الأوفق منها، وعن طريق تفعيل آليات الاستنباط المقررة في علم الأصول، ولكنهم لم يوصلوا خطابهم إلى مستوى رفع التناقض بين هويتهم الإسلامية وهوية الحضارة الغالبة التي تدعي أنها كونية ولا مجال فيها للخصوصيات. وقد أعطينا أصحاب هذا الاتجاه اسم “المدرسة الفروعية المذهبية”.
مجموعة تقول بإمكانات انفتاح النص وتعدد قراءاته بحسب الظروف والسياقات معتبرين أن النص يسير جنبا إلى جنب مع العقل ويدور معه حيث دار.وبالتالي فكل ما فيه مصلحة ينبغي أن يجد مكانه في التشريع. وقد أطلقنا على أصحاب هذا الرأي اسم”المدرسة التجديدية الأصولية”.
نرى أن الميزة الأساسية للمجموعتين الأوليين هي أن أصحابها ينطلقون في الغالب من النصّ إلى الواقع، فالنصّ هو الفاعل أما الواقع فهو التابع المنفعل. وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة الواقع قبل مطالعة النص فإنهم يراجعونه من منطلق الحاجة إلى تحقيق مناط الحكم، حتى يتم وضع الحكم الصحيح في مكانه الصحيح. كما نرى أن السمة الفارقة لأصحاب المجموعة الأخيرة هي أنهم على خلاف المجموعتين الأوليين ينطلقون من الواقع إلى النص متعللين بقلة النصوص القطعية:
ورودا ودلالة، وبدور نظر العقل السليم في التشريع انطلاقا من محدودية النصوص وكثرة الوقائع المستجدة.لذا جاءقولهم بحاكمية الواقع مضخما إلى حد كبير، ودرجة إحساسهم وانفعالهم به طاغية على تفكيرهم.فجعلوا الواقع مؤثراً معرفياً وإيبستيميا في النص لحد أنهيقيدمضمونهويعيد قراءته طبقاً لمتطلّباته. إننا إذا نظرنا إلى أصحاب المدرستين النصية/السلفيةوالفروعية/المذهبية،الذينيشكلونالكم الأكبر من تعداد المسلمين لأنهم همأتباع المذاهب الفقهية والعقدية والصوفيةالمنتشرة في العالم الممثلون لجمهور الأمة وقاعدتها الواسعة،نجدهم يختلفون في مقدارالهامش الذي يعطونه للواقع في التأثير في الأحكام. فمنهم من يقلص هامشه كثيرا لحد الامتناع من إعماله وهم في الغالب من مدرسة النص، ومنهم من يعطيه هامشا من التأثير يضيق ويتسع بحسب المدارس والملابسات وهم أصحاب المدرسة الفروعية، وإن اتفقوا كلهمعلى أن الأداة المنهجية المستعملة في تقدير مُعامِلات الواقع الفاعلة في التشريع يجب أن تنضبط بالضوابط التي وضع الأقدمون لكي لا يكون الدين هزؤا وتسقط حكمة التكليف والطاعة. أما أصحاب المدرسة التجديدية فيرون أن وسائل استنباط الأحكام الشرعية المعروفة في أصول الفقه قد استنفدت طاقاتها التوليدية المسموح بها، فلم يبق أمام المهتمينبأمر المسلمين إلا إعادة النظر في فلسفة التشريع ومحاولة تجديد أصول الفقه لإنشاءأداة تشريعية قادرةعلى النظر في المستجدات وتفقيه مختلف مظاهر حياة المسلمين.لهذا كان الأخذ باستحسان العقل باعتباره أحد المصادر المستقلة (وليس المعارض) للفقه، مع ضميمة النظر في المصادر الأخرى (القرآن والسنة والإجماع) أخذا بقاعدة تلازم حكم العقل والشرع، السمةَ البارزة في البحث الفقهي عند أصحاب هذه المدرسة. ولهدف إعطاء المصداقية اللازمة لهذا المشروع الفكري والسياسي، تعاظم العمل عندهم بدليل الاستصلاح والمقاصد والمآلاتلمواجهة تحديات قوية الشحنات الدهريةلابد من إيجاد حلول مناسبة لها لما ينبني عليها من تأثير في الشعوب هدف الاكتتاب والحشد سلبا أو إيجابا، خاصة أن فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية كما بينتها كتب الأحكام السلطانية لا تلقى أي نوع من الترحيب من المجتمع الدولي عموما ومن التيارات الليبرالية أو الحركات العلمانية في بلاد الإسلام التي تريد بناء دول محايدة دينياً، تكون مسألة اتباع الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا فرديا خاصا. ومن الواضح البديهي أن أصحاب المدرسة التجديدية عموما قد وقفوا أمام سؤال كبير ومتشعب يتعلق بمدى انسجام أو تناقض تعاليم الإسلام مع هذا الكل الوافد من الغرب بشتى تفاصيله ومستوياته. إن هذا السؤال يطرح أكثر من إشكال خاصة إذا انطلقنا من أنه حتىالعلوم تبدو في التحليل النهائي غير حيادية في صياغتها وفروشها ومنطلقاتهاكما بينت الدراسات المعرفية والنفسية.فهيمتأثرة بالغ التأثر بوسوم الخلفية العقدية والاجتماعية والإنسانية لمنتجيها. فالتضاد بين المادة والروح الذي بشرت به الفلسفة اليونانية هو في الواقع المبدأ الذي يؤسس المعرفة الغربية في مجملها وهو الذي أوجد فكرةالتقابل بين السياسة والناس والعقل من جهة وبين الدين والأخلاق من جهة أخرى. فكانت القطيعة بين الدين والدنيا أو المعبد والدولة إحدى مظاهره البادية للعيان. ولقد تكرست هذه القطيعة بظهور النزعة العقلانية التي رفدتها ميتافيزيقية كانت، وواقعية ديكارت وميكانيكية نيرتونيفقوت فكرة أصالة المادة ووحدتها، وداخلت هذه الفكرة مختلف العلوم الطبيعية والاجتماعية والسياسية والقانونية. ومن هذا المنطلق نشأت نظريات دهرية كنظريةالحق الطبيعيالتي تعتبر الطبيعة مرجعا كونيا بعيدا عن الثقافة وإرادة المشرع (روسو) وكنظرية الحق الإيجابيذي البعد النفعي (جيرمي بنتام)التي جعلت من الحقوق مادة تصاغ عبر الانتخابات والقوانين والدستور والقرارات البرلمانية. لذاما إن تنبه بعض المفكرين من المسلمين إلى أن أساس “العلموية” يقوم على مبدأ إقصاء الدين من كل محطات مسار العلم حتى بدأت القناعات تهتز وصار البناء النظري للتجديد على شفا الانهيار لما بدا فيه من الخداع والمغالطة. فاقتنع عندئذ هؤلاء المفكرون بضرورة إعادة النظر في “اليقينيات المحايدة” التي ظلت إلى حد قريب معطى متفقا عليه معلوما بالبداهة، وبرزت نظرية “أسلمة المعرفة” أو “إسلامية المعرفة” عند مفكرين إسلاميين من ذوي الاطلاع على العلم والفكر الغربيين وإلى ما يتأسس عليه من خلفيات فلسفية تقوم على نقيض التصورالإيماني. غير أن نظرية “إسلامية المعرفة” هذه ما ولدت حتى بدأت تتآكل وتذبل.ولعل أولعائق واجهتههوالعائقالمنهجي المتعلقبتحديد العلم. فالعلم وإن كان بناءات نظرية تفسيرية تقارب الواقع وترمزه، فهو أيضا إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا لم يدرك على ما هو عليه فلا يسمى عندئذ علماولو اتصف بشروطه الإبستمولوجية المعروفة كالصورية والانسجام والحياد. 2. النوازل الطارئة وكيفيات معالجتها من خلال تتبع أجوبة وفتاوي أصحاب المجموعات الثلاث السالفة الذكرحول القضايا المطروحة في الساحة بشيء من التفصيل ندرك آليات النظر الاستنباطي المستخدمة فيأشكال تفكيرهمحول طبيعةالموقف اللازم اتخاذهمن مفردات الحضارة الحديثة المادية واللامادية. لقد شعر الفقهاء والمفكرون المسلمون المعاصرون بقوة التحدي الذي يواجهون خاصة مع طلب المسلمين المتزايد والضاغط عليهم من أجل التيسير ورفع الحرج و”إتاحة فرص التدين” وأمام المستجدات التي فرضت نفسها على مجتمعات المعمورة جميعا، فحاولوا أن يقدموا إجاباتوإن ظل أغلبهم محجماعن الإدلاء برأيه لعدم وجود نصوص من الأقدمين أو لعدم انسجام هذه المستجدات والفقه المتاح. ومن المعروف أن هذا الهم لمتمثل في “تفقيه”مخرجات المدنية الحديثة، قد بدأ يحتل مساحة كبيرة من فكر المسلمين من أيام جيل النهضة حين تم الاحتكاك شبه الدائم بالغرب. فتسائلشكيب أرسلان: “لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم”؟ذلك الاستفهام الذي فتح الباب للتفكير فيإمكانات المزاوجة بين الخصوصية الثقافية الإسلامية والمشترك الإنساني العام.