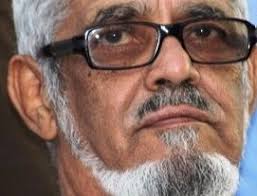“بن زريق” الصحراءمن “اباه” إلى “الباهي”

الزمان انفو ـ
كان الصبي اليتيم أعجوبة الذكاء والنبوغ.. كان ذهنه أصفى من المرآة تقابل الشيئ فينطبع فيها بجلاء.. عقله الحاد كنصل الخنجر، وذاكرته البدوية السيالة، ربما هما سبب حظوته لدى اشياخ محظرته، فلم يكن بإستطاعة صبي غيره في الحي أن يحفظ ثلاثة “أثمان” كل يوم وقصيدة عصماء من مطولات الشعر الجاهلي… لقد كان نسوة الحي يرددن عندما يتحدثن عن نبوغه: “رحم الله محمدا، لو أمهله العمر لسرته نجابة أباه!”.
كان الصبي يسكن مع عمه صحبة أخته الصغيرة “عزة”، وكان العم يوقظه إذا ألقى الليل جرانه، ليعلمه منازل النجوم ومطالعها، وليختبره في معرفة الوقت من خلالها.. وكان يردد عليه كثيرا: “إن البدوي يا ابني إذا لم يتقن معرفة المنازل مات عطشا”.. ولقد علمه كذلك أن يترجل الأميال الطويلة دون تعب، وأن يضرب بأقدامه كل شبر من أرض “العكل”، وأن يتعلق بأذناب البعران لينزوي على ظهورها.. غير أن الصبي أراد ان يتعلم أشياء اخرى لم يتعود أطفال الحي تعلمها، وفكر في أمور لم تخطر لهم على بال. تعلم الفرنسية فتفتحت مغاليقها في ذهنه، وتعلم من قريبه حرمة بابانا مفردات السياسة والنضال والمقاومة.
ومن السير عشرات الأميال في الصحراء يتقفى آثار السوائم، تعلم الضرب في بلاد الله الواسعة:
كانت اولى محطاته السنغال، الدولة الإفريقية التي أنهلته من معين لغة موليير، احبها، إلا أنه لم يجد، رغم كل الأشياء المختلفة فيها عن الصحراء، ما يدفعه لأن يلقي فيها عصا تسياره. فحملها على عاتقه وواصل السير.
اما “المغرب” فصادفت هوى في قلبه.. لم يبخل عليها بشيئ..أعطاها كل ما يملك: بندقيته، فأنضم لـ “جيش التحرير”، وقلمه، فكتب في كبريات صحفها ومجلاتها، ونضاله الدؤوب فانتسب “لإتحادها الإشتراكي، ولم يكفه ذلك فغير اسمه من “اباه” إلى “الباهي”، ليكون بذلك مغربي الإسم والوسم.
فتحت له أبواب المغرب على مصراعيها، واستقبلته في حضنها استقبال الأم لوحيدها، رغم أنها لم تكن أمه ولم يكن وحيدها..عاش فيها طارقا كل أبواب النجاح، سياسيا محنكا وكاتبا مرموقا وصحفيا من الطراز الأول.. كل زاوية في جسم المغرب تألف دغدغة أنامله، وكل مقهى تعود صوت رشفته من الفنجان، وكل قرطاس في جريدة مغربية هفا إلى مداعبة أقلامه، وفي كل ناد صدى لقهقهته المجلجلة كرعود تعد بالماء، وله مع كل رجل فكر أوسياسة فيها علاقات حميمة، من المهدي بن بركة إلى عبد الرحمن اليوسفي ومحمد عابد الجابري.
وفي الجزائر أيضا كانت للرجل وقفات .. حمل السلاح ضد فرنسا، وصدع بنصرة العدل والوقوف مع المظلومين، رفع بإحدى يديه قلما وبالأخرى مدفعا..ولم يوفر جهدا في مؤازرتهم، حتى كان النصروالاستقلال.
وعندما عرض عليه الجنرالات الجزائريون رئاسة “جبهة البوليساريو”،لم تهن عليه بلاده المغرب، فرفض خيانتها بكبرياء.
وبطبيعته البدوية الرحالة، حمل الصعلوك نمرقه وقرابه وواصل تسياره إلى بيروت، كانت لبنان حينها عاصمة الثقافة والصحافة والفن.. وأعجوبة العالم في الحضارة والإعمار، فكان الأمر أشبه بورود علي بن الجهم على الرصافة والجسر و بقدوم حاجب بن زرارة إلى بلاط كسرى انوشروان.
وتلقفت بيروت البدوي الزائر، الذي كان يحفظ الاشعار الجاهلية عن ظهر قلب.. ظل يتردد بـ “الدراعة” على مطعم “الفيصل”.. يسمعه كمال ناصر من أشعاره، فيطرق ساعة ثم يقول، من غيرمجاملة: “الشعر بدأ بالجاهلي، ثم بصدر الإسلام فالعهد الأموي ثم توقف حماره عند عقبة عصر العباسي.. لم يتجاوزه!.. نحن في موريتانيا لا نعترف بما كتب بعد ذلك من شعر!”، يضحك رواد المطعم وكلهم من الأدباء والمثقفين، ولكن لذاعة النقد لا تغضب كمالا، فقد كان من المستحيل ان يغضب جفاء ذلك البدوي أحد، خفة دمه وحلاوة معشره كانا شفعائه من موجدة الأصدقاء.
وفي “الانكل سام” ينادم على الجعة محمد الماغوط وعلي الجندي، فينشدهما للشماخ ابن ضرار والمرقش وتوبة ابن الحمير، فيشقان برديهما طربا ويصيحان ملء حنجرتيهما:”يالك من بدوي ظريف!”.
وفي “الهورش شو”.. جلس ينظر لإصلاح العالم، ويناقش خطط انتشال العرب من مستنقع “النكسة”، فتنبهر أنفاس رفيق شرف وعصام محفوظ، “فكيف يفهم الصعاليك هكذا في السياسة!”
وعلى طاولته في “الحمراء” يجلس في انتظار ميشال جودة، الذي لا يخلف له موعدا، فيدردشان، ويناقشان حدث الساعة.
.. عاش الرجل أروع أيام حياته في بيروت، وأرعف يراعه على كل ورقة فيها، وحرض للوحدة والثورة على أثير “صوت العرب”.
قادته أقدام “الإشتراكية” التي كانت دليله إلى كوبا، فتسكع في شوارع هافانا يبحث عن رجل نحيف ذي لحية كثة، فألتقى بتشى غيفارا وعاد يتغنى بالشيوعية مثالا للفضيلة والنبل.
ويحط الباهي رحاله في باريس، راقت المدينة المتوهجة للبدوي ذي السحنة والشعر الأجعد، وراق لها أيضا، كأنهما عاشقان كانا على موعد، وكأن ظل ينتقل منذ الأزل من صلب إلى رحم ليلتقي حبيبته باريس.
عرفها كما لم يعرف أودية ” لعكل” وأجراعها، ألف السير في طرقاته كما كان يسير خلف عمه في وديان “اندابيسات”، فقليلة جدا المرات التي ركب فيها “المترو” والاقل منها ان يركب “التاكسي” !.
قضى الرجل نصف عمره في مقاهي باريس، وكان يرتاد مقاهي الفقراء على وجه الخصوص، فكم دعوة لمقاهي “الشانزليزيه” وحاناتها، من ثري عربي تعبق من برديه أنفاس الخمر والنفط، اعتذر عنها الرجل الذي يكره “الاغنياء الأجلاف” كما كان يسميهم.
لقد كان بإستطاعة ذلك البدوي القادم على راحلته من تخوم الصحراء أن يخبرك أي المقاهي تعود همنغواي على ارتيادها، وفي أي مقهى يقيم سارتر أو ديدرو أو بيكاسو أو المجنون سلفادور دالي.
يقول عبد الرحمن منيف:” تتوقف عند مكان، لاشيئ من منظره الخارجي يدل على أنه مقهى، لكنه يقتحم ويصعد إلى الطابق الثاني، وبعد ان يجلس إلى طاولة رخامية معينة، يبتسم ابتسامة طاهرة مع سؤال لايخلو من تحد: أتعرف من كان يجلس على هذه الطاولة قبل قرنين؟! وحين تبدي عجزك يقول بعد فترة صمت طويلة: على هذه الطاولة كان يجلس فولتير.. أو فيكتور هيجو”.
وعند رأد الضحى، أو عندما تكون الشمس في طفلها، يسبأ الباهي قنينة من النبيذ البلجيكي المعتق، ويسير على أقدامه إلى “مقبرة الكلاب” في وسط المدينة، يمسك كأسه بيد مشدودة ثم يستقبل الشمس التي تغازل البزوغ أوتجنح للغروب، فينشد من رقيق شعر ابن الدمينة، وحشرجة البكاء تعيق ذبذبات صوته:
أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب
ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب
وهل ريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها او أن يحن نجيب
وإن الكثيب الفرد في جانب الحمى
إلي وإن لم ءاته لحــــبيب
وينظر إلى قبور الكلاب وقد ترقرق دمعه، فيهمس لنفسه متأثرا: “لو كنت أعلم أن البشر أحسن من الكلاب لما كلفت نفسي زيارة قبورها..إذا كان الإنسان أشرف مخلوقات الله بعقله فإنه أنذلها بأخلاقه”
… لقد كان النبيذ أحد خلصائه، يعاقره في سكون الليل، ووحدته إلا من حنينه وهواجسه، وحين يكون مذاق النبيذ جيدا “يقترح على الندماء عشرات المشاريع والأفكار من أجل إعادة تنظيم العالم” ثم يختم بدمعة يغالب أن لا تتحدر..
يجن الليل الباريسي ويعتكر فيجن جنونه ويحن، ويعيد إليه شريط ذكرياته أنتظار أخته “مريم” لعودته التي طالت، فيستبدبه الحزن، وينسد الأفق، وتضيق مساحة الرؤية، ويجثم شيئ ثقيل على صدره، فيصيح:
-الليلة كلها لمالك بن الريب!
ألاليت شعري هل أبيتن ليلــــة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ماشى الركاب لــياليا
وليت الغضا يوم ارتحلنا تقاصرت بطون الغضا حتى أرى من ورائيـا
لقد كان في أهل الغضا لودنا الغضا مزار ولكن الغضا ليس دانيــــا
أجبت الهوى لما دعاني بزفـــرة تقنعت منها-أن ألام- ردائيـــــا
تذكرت من يبكي علي فلم اجـــد سوى السيف والرمح الرديني باكيــا..
ولعل المسكين نسي أن من اشد الباكين عليه حرقة: الكتب، لقد كان قارئا نهما.. اقتنى من عجائب الكتب ونوادرها، مطبوعا ومخطوطا، ما عجزت الرفوف عن حمله فكدسه في صناديق خشب، كتب في الفكر والسياسة، وكتب في الادب والتاريخ، وكتب عن الحيوانات، وأخرى عن النباتات والأعشاب، وأخرى عن موضوعات غريبة قد لا تخطر لك على بال: مشاهير العزاب، طبائع القطط، صناعة النبيذ والعطور، تاريخ الكنائس في اوروبا.
ولم يكن صاحبنا في باريس مجرد عربي مغترب يمتهن الصحافة، والترجمة بين العربية والفرنسية، اللغتين التي يمتلك نواصيهما، وإنما أقام علاقات وطيدة بالساسة الفرنسيين، وانخرط بإخلاص للنضال مع اليسارالفرنسي.
تعبت عربات الرجل من الضرب في عراض الأرض، لقد وهن منه العظم وأصبح في حاجة إلى ظهر يسنده، لن يكون مئاله إلى دار مسنين في بلاد الإفرنجة، لذلك فقد قرر العودة الي “المغرب”.
عاد إليها.. وأوكلوا إليه في “الإتحاد الإشتراكي” المسؤولية الإعلامية في الحزب، ولكن اليعاسيب ثارت من أوكارها، وأصطدم الرجل الحساس الرقيق المشاعر ببعض بارونات الحزب… فأصابه أنهيار عصبي وهو في مطار المغرب مغادرا إلى فرنسا. وكأن في الأمر تلويحا بنهاية الرحلة من حيث بدأت:”المطار”.
مات الرجل غريبا، شاحط الدار، ولم يخلف غير كتب ومقالات وأبنة تعمل في موسكو، في حقل المعلوماتية.
اما أخته”عزة” فلاتزال بـ”جنب الغضا”، تتلع بجيدها نحو الأفق البعيد، منتظرة على جمرعودة أخيها “اباه”، الذي غادر الحي على ظهر أتان.
محمدالحنفي دهاه